د.أحمد خيري العمري - القدس العربي
رسالتان من فلسطين المحتلة، مختلفتان في التفاصيل، متشابهتان في الجوهر، واحدة من غزة المحاصرة والأخرى من سجون الاحتلال، حسمت مع الثانية ترددي في الرد على الأولى، وكنت قد رددت فعلاً بشكل شخصي على الرسالة الأولى ولكن ليس كما طلبت صاحبة الرسالة..
الرسالة الأولى من قارئة فاضلة في غزة، طالبتني بالمشاركة في حملة لرفع “الحصار الفكري” عن غزة، وهي حملة ينظمها بعض الناشطين الأفاضل على الإنترنت ومن ضمنهم القارئة نفسها، وتركّز على جمع الكتب والمطبوعات في عنوانٍ جغرافيّ محدّدٍ، ومن ثم محاولة تمريرها إلى غزة..
رددت يومها وفوراً على الأخت رداً لا أشكّ أنه خيب أملها، ولكني لا أشكّ أيضا في صدقه ولا أتنصل منه، إذ طلبتها بتزويدي بالعنوان المحدد تفصيلياً وذلك لكي أرسل- ومعارفي- كل ما يتيسّر من كتب، لكني أوضحت أنّي أشارك بصفتي الشخصية المجردة عن كوني الكاتب أو المفكر أو أية صفة اعتبارية أخرى..
كان من الواضح طبعاً أن طلب الأخت الغزاوية لا يتعلق على الإطلاق بصفتي الشخصية وإنما بصفتي ككاتب مساند للحملة، أي ككاتب يضاف إلى مجموعة الأسماء المساندة والداعمة للحملة….. ( علماً أن أي مطرب شاب “نصف وسيم وربع موهوب” يظهر على القنوات الغنائية يمكن له أن يجمع “عدداً” أكبر من المساندين للحملة أكثر من أي كاتب آخر له من الشهرة أضعاف ما أملك).. لا أقلل هنا من أهمية “العمل الخيري” في دعم حصار غزة أو أي حملة مشابهة، لكن لا بد من الفصل بين دور الجمعيات الخيرية ودور المفكرين والمثقفين..
رغم خيبة الأمل التي بلا شكّ سببتها للأخت الفاضلة، لكني شخصياً لا أستطيع أن أساهم فيما أعتبره على المدى البعيد تكريساً للوضع القائم عبر تقديم حلول جزئية لأعراض مرضية لا أشك في خطورتها لكنها في الحقيقة جزءٌ من مرض لا بدّ من مواجهة جذوره، وتقديم الحلول السريعة( لأعراض المرض دون استئصال أسبابه) يساعد على نحوٍ ما في تكريس الوضع القائم الأساسي- أي المرض- الذي أنتج هذه المشاكل ابتداء..
بعبارة أخرى: لا أشك للحظة واحدة أن الإخوة في غزة، وحصارهم الذي ينهي عامه الثالث قريباً يحتاجون إلى إمدادات متنوعة من أجل استمرار بقائهم على قيد الحياة بالمعنى المباشر أولاً، ومن ثم لتأمين احتياجات أخرى لا تقل أهمية، ومن ضمنها الكتب والمطبوعات، ولكن ذلك كله - وإن ساهم في صمودهم وبالتالي في تجريد الحصار من أهدافه- إلا أنه في الوقت نفسه لا يتعرض ولو قليلاً لمجموعة الظروف المعقّدة التي أدّت إلى هذا الحصار ابتداءً، أو على الأقل ساهمت فيه من طرف ما، وهي مجموعة ظروف قد تبدو سياسيّة للوهلة الأولى، لكن هناك امتدادٌ ثقافيّ لها كما لكلّ شيء، وبالامتداد الثقافيّ أقصد مجموعة المفاهيم والتصورات والرؤى التي تسود في مجتمع ما، وهي مفاهيم لا أشكّ للحظة أن البعض منها بسلبيتها يساهم في إبقاء الأنظمة السياسية ذاتها التي تساهم في هذا الحصار أو في سواه..
دورنا كأفراد ربما يمكن أن يتساهل مع الحلول الجزئية ومنطق تكفير عن الذنب – وهو أفضل حتماً من منطق حملات “الصيام من أجل غزة “والصيام من أجل العراق التي لا تعدو أن تكون استهلاكاً شعائرياً لطاقة العمل من أجل التغيير دون أي تغيير حقاً – ولكني أفترض وأتمسّك بأنّ دور المفكر والمثقف يجب أن يكون أبعد من ذلك بكثير مهما كان الأمر، بل إني أؤمن جازماً أنّ تسويق المفكرين والمثقفين للحلول الجزئية يحملهم خطيئة الإبقاء على الوضع القائم برمته، وأقول ذلك حتى لو كان سيُفهَمُ أنه دعوة إلى الثورة أو الانقلاب على تلك الأنظمة التي لا تستحق شيئا آخر، ذلك أن الدعوة إلى الثورة (رغم تراث الخيبات من المصطلح والتجارب الثورية!) تبقى أفضل من الدعوة إلى الانتحار الجماعي، وهو ما أؤمن أنه الموازي الحقيقي للبقاء في الوضع الراهن..
و هكذا فإن حملات كهذا – بأهداف جزئية كهذه، على نبلها- تساهم قي صرف الأنظار بعيداً عن العمل الحقيقي الجذري الذي يساهم في استئصال جذور المشكلة حتى ولو كان هذا الحل لا يأتي إلا بعد فترة طويلة من الزمن، وربما بعد أن يمضي الجميع، لكن هذا هو جزءٌ من طبيعة الأشياء، أو على الأقل هو جزءٌ من دور المفكرين وتوصيفهم الوظيفي، إنهم لا يملكون عصا موسى التي تقوم بالتغيير في برهة واحدة ( بالمناسبة حتى عصا موسى لم تنجح في تغيير قوم موسى!)..لكنّ دورهم هو في تغيير المفاهيم التي تشكل البنية التحتية للأمة، أي المنبع لكل الأمراض التي تعاني منها هذه الأمة..
وهكذا فان حصار غزة يمكن أن يُعَدّ مثالاً نموذجياً لأزمة تعصف بمنطقة محدّدة جغرافياً وزمانياً، لكنّ أسبابها وجذورها تمتدّ لتغطي جزءاً كبيراً من تاريخنا من المحيط إلى الخليج، الأمر لا يعود إلى كيانٍ استيطانيّ- لا حقّ له بالوجود أصلاً- مدعوم من قوى دولية وجدت فيه امتداداً ثقافياً وسياسياً لها فحسب، بل هو يعود أيضاً إلى مجموعة متراكمة من العوامل الداخلية التي جعلت بقاء هذا الكيان ممكناً، بل وتعايشت بالتدريج مع كونه أمراً واقعاً: هناك ذلك العقل الجمعي القبلي الذي يجعل الكل متحيزاً لعشيرته أو قبيلته أو منطقته دون أن ينضج ليطور مفهوماً أوسع لوطن، ومفهوما أوسع وأنضج لأمة ( إلا في الدعاء والبكاء والعويل بطبيعة الحال، والذي يعمل دوماً على استهلاك طاقة العمل، وبالتالي الإبقاء على حالة اللاعمل).. هناك حالة الرضوخ للأمر الواقع التي كرّسها الفهم السلبي لعقيدة القضاء والقدر التي لو آمن المسلمون الأوائل بها على هذا النحو السلبي لما انتشر الإسلام ولما فتحوا العالم، هناك كوم هائل من الفتاوى التي تكرس الرضوخ للسلطان مهما كان ومهما فعل، والتي تستند على فهمٍ سلبيٍّ لنصٍّ صحيح أو مجتزأ أو على نصٍّ ضعيف أصلاً.. كما هناك الفهم السلبي للرضا بالنصيب والرزق الذي ساهم بتكريس أوضاعٍ مجحفةٍ استغلّها التحالف المزمن لرأس المال مع السلطة أبشع استغلال..
كل هذه المفاهيم هي الرصيد الحقيقي لكل الأنظمة المستبدّة في عالمنا العربي، هناك طبعاً القمع والسجون وتكميم الأفواه كما هناك الترغيب والمناصب والأموال، لكن هذه المفاهيم هي الاستثمار الحقيقي الذي يضمن بقاء تلك الأنظمة التي تعاونت بلا حدود مع كلّ أعداء الأمة في سبيل بقائها واستمرارها، لقد تمكنت – عبر هذه المفاهيم- لا أن تروِّض شعوبها فحسب، بل تمكّنت أن تساومها على رغيف خبزها وكل أساسيات عيشها، وتأمن بالتالي من ثورتها وتمردها تماماً..
حصار غزة، وتواطؤ الأنظمة العربية عليه هو مثال على ما ذكرت، لن يضير نفس النظام أن يمرر بعض قوافل الإغاثة بين الحين والآخر، أو أن يسمح بتنظيم بعض الحملات، ومن ضمنها حملة جمع الكتب المشار إليها، فتلك حلول جزئية تلعب دور التنفيس الذي يؤجل الانفجار ويمنح هذا النظام وجهاً أفضل يحتاجه بين الحين والآخر..
الرسالة الثانية كانت من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وعلاقتي بهم كانت علامة في طريق كلماتي منذ أن تواصلوا معي للمرة الأولى منذ أشهر، وكنت تواصلت معهم قبلها دون أن أدري عبر كتبي التي اخترقت الزنازين، رسالتهم هذه المرة كانت تطالبني بـأن أكتب لهم في يوم الأسير الفلسطيني، تذكيراً بقضيتهم التي لم يعد يذكرها أحد إلا في المناسبات وفي مواسم الابتزاز الانتخابي – المحلي والمحدود جداً أصلاً -.. وها أنا ألبي طلبهم وأنا محمَّل بعاري: عار أن تكتب وتنظّر مسترخياً وأنت في بيتك وبين أولادك بينما يقضي هؤلاء- وسواهم أيضاً في بلدي العراق- العام تلو العام وهم خلف الزنازين والقضبان لا لذنب ارتكبوه غير أنهم دافعوا عن أبسط مقومات حياتهم..
من السهل جداً أن أكتب لهم عن كونهم يتحملون العبء كله بالنيابة عن الأمة والتاريخ وكل القيم، وأنّ الأجيال القادمة التي ستقطف ثمار تعبهم لن تنساهم، من السهل أيضاً أن أقول: إننا لا ننساهم أيضاً – في دعائنا وصلواتنا، وإنه لا يمر يوم دون أن نذكرهم فيه، من السهل أن أعظهم وأوصيهم بالصبر أيضاً، وهم أولى حتما بوعظي بذلك، ولا اشكّ أنهم سمعوا وحفظوا عن ظهر قلب كل ما يقال في “مناسبات” كهذه..
أشعر أن ذلك كله ( رغم صدقه أحياناً ) قد استُهلِك تماماً، وأشعر أنّ من حقهم علينا أن يسألوا: وماذا بعد؟.. ماذا لدينا غير ذلك الكلام الذي لا يكون أحياناً أكثر من مجرد “أكليشيهات” مكررة؟
بصدق أقول لهم: لا شيء سوى الخيبة من ذلك كله، الخيبة حدّ القرف، حد الامتلاء، لم يعد هناك ما يمكن أن يقال إلا وقد قيل، ولم يعد هناك من أمل عاجل حقاً، ما أدخلهم تلك المعتقلات لم يكن سلطات العدو فحسب، بل ثقافة كاملة تعايشت مع كلّ ما هو سلبيّ وكرست التفتت والتخاذل، ثقافة خرجت من مكوناتها القرآنية الأصلية وجعلت من معسكر الأسر عنوانها الدائم، ولا سبيل للخروج من الأسر إلا بإخراج هذه الثقافة من أسر تراكماتها السلبية التي أضعفت مناعتها وجعلتها عرضة للاستلاب الحضاريّ من جهة، كما أخرجتها عن حقيقة قيمها ومكوناتها الفاعلة من جهة أخرى..
عملية تحرير هذه الثقافة من أسرها هي عملية إخراج الأمة بأسرها من كلّ معوقات نهوضها، وهي عملية تتطلب الدخول في حقل ألغامٍ تاريخيّ يحيط بهذه الثقافة من كلّ الجهات، بل إن الأسير نفسه قد يرفض أحياناً الخروج من الزنزانة، لقد تعود على قضبانها وجدرانها وصار لا يتصور إمكانية وجود عيش خارج هذه الزنزانة.. إنه هو الأسير وهو السجان في الوقت ذاته في الكثير من الأحيان..
عملية تحرير الثقافة الأسيرة وإطلاقها في فضائها الأصليّ الفاعل عملية ليست يسيرة، وهي تستغرق وقتاً طويلاً جداً في أفضل الظروف وأكثرها ملائمة، ولذلك فهي لا تدخل ضمن وعود القادة السياسيين وبرامجهم الانتخابية لأنهم لا يستطيعون حتى الوعد بتغـييرها ( هم نادراً ما ينفِّذون أيَّ وعدٍ على الإطلاق، لكن دعوى كهذه ستكون مفضوحة ابتداءً)..
رغم كل ذلك، فهذا ما يجب أن يحدث، يوماً ما ستعي الأمة أن البقاء في معسكر الأسر سيجعل من استلابها يتحول إلى إيدز حضاري غير قابل للشفاء، فإما أن تُمسَخ تماماً وتفقد كلَّ مكوناتها وثوابتها، أو تنقرض تماماً.. تماماً..
يوماً ما ستعي الأمة هذا، وستتَّخذَ قراراً باتِّجاه طريقٍ ثالثٍ لا نجاة إلا من خلاله، طريق يخرجها من معسكر أسرها دون أن يضعها في معسكر أسر الأعداء..
وريثما يحدث ذلك، لا أملك للأسرى في سجون الاحتلال إلا صدقي وعاري كله، أهديه لهم أنا أدرك جيداً أنه لن يجدي في اللحظة الراهنة.. لكنه كل ما أملك.. مع شديد الأسف..
الكلمات الدلالية (Tags):
لا يوجد
-
 ثقافه في معسكر الاسر---
ثقافه في معسكر الاسر---

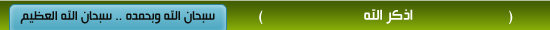
الدمعه- طيف- رضى رزقتم الجنه بلا حساب ----والجميع----






