المعيار الشرعي لمعرفة المصلحة والمفسدةد. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان
(1ـ2)
لقد جاءت الشريعة الإسلامية بكل أحكامها وأوامرها ونواهيها لتحقيق المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها، قال الله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ}، ولو كان في هذه الشريعة شيء خلاف المصلحة الحقيقية لم يصح وصفها بأنها رحمة للعالمين، وبين الله تعالى صفة رسوله عليه الصلاة والسلام والغاية من بعثته فقال: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} فهو صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالمعروف الذي أمر الله به وتعرفه وتقره العقول والفطر السليمة، ولا ينهى إلا عن المنكر الذي نهى الله عنه وتنكره وتأباه العقول والفطر السليمة، ولا يحل إلا ما أحله الله من الطيبات النافعات، ولا يحرم إلا ما حرمه الله من الخبائث المضرات، ودينه هو دين الحنيفية السمحة ، ومبناه على التيسير ورفع الحرج.
وقد أجمع العلماء على أن أحكام الشريعة الإسلامية مشتملة على مصالح العباد، ومحققة لها، ووافية بها، سواء أكانت ضرورية أم حاجية أم تحسينية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى 11/347): "ولا يمكن للمؤمن أن يدفع عن إيمانه أن الشريعة جاءت بما هو الحق والصدق في المعتقدات، وجاءت بما هو النافع والمصلحة في الأعمال التي تدخل فيها الاعتقادات".
وما ذكره شيخ الإسلام هو معنى قوله تعالى عن القرآن العظيم: {وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً}، أي: صدقاً وحقاً في جميع أخباره، وعدلاً وصلاحاً في جميع أحكامه وتشريعاته.
وللإمام ابن القيم كلام نفيس في تقرير هذه القاعدة الجليلة التي لا يشذ عنها شيء من أحكام الشريعة سواء أكانت من المأمورات أو المنهيات، حيث يقول في (مفتاح دار السعادة 2/22-23): "وإذا تأملت شرائع دينه التي وضعها بين عباده وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، وإن تزاحمت قدم أهمها وأجلها وإن فات أدناها، وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، وإن تزاحمت عطل أعظمها فساداً باحتمال أدناها.
وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين شرائع دينه دالةً عليه، شاهدةً له بكمال علمه وحكمته ولطفه بعباده وإحسانه إليهم. وهذه الجملة لا يستريب فيها من له ذوق من الشريعة وارتضاع من ثديها وورود من صفو حوضها، وكلما كان تضلعه منها أعظم كان شهوده لمحاسنها ومصالحها أكمل... والقرآن مملوء من أوله إلى آخره بذكر حكم الخلق والأمر ومصالحها ومنافعها، وما تضمناه من الآيات الشاهدة الدالة عليه...
وإذا تأملت الشريعة التي بعث الله بها رسوله حق التأمل وجدتها من أولها إلى آخرها شاهدة بذلك ناطقة به، ووجدت الحكمة والمصلحة والعدل والرحمة بادياً على صفحاتها، منادياً عليها، يدعو العقول والألباب إليها"
فالشريعة إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد، وما من حكم شرعه الله إلا وهو جالب لمصلحة أو داريء لمفسدة، أو جالب وداريء في آن واحد.
قال الإمام الشاطبي في (الموافقات 1/199): "المعلوم من الشريعة، أنها شرعت لمصالح العباد، فالتكليف كله، إما لدرء مفسدة، وإما لجلب مصلحة، أولهما معا".
والمصلحة ضد المفسدة، والمراد بالمصلحة ـ كما قال أهل الأصول ـ: هي المنفعة أو وسيلتها التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم.
فهي تطلق على المنفعة ذاتها، كما تطلق على وسائلها المفضية إليها، مما هو داخل ضمن مقاصد الشريعة الإسلامية، ومن تتبع كتب الأصول، أدرك هذا جلياً، حيث يجدهم تارة يطلقون المصلحة على المنفعة، وتارة يطلقونها على أسبابها الموصلة إليها، قال العز بن عبد السلام في كتابه القيم "قواعد الأحكام 1/12": "المصالح ضربان: أحدهما حقيقي وهو الأفراح واللذات. والثاني مجازي، وهو أسبابها"، وقريب من هذا قول ابن القيم في "مفتاح دار السعادة 2/14": "المصلحة: هي اللذة والنعيم وما يفضي إليه. والمفسدة: هي العذاب والألم وما يفضي إليه".
والمراد بالحفظ في التعريف هو مراعاة هذه المصالح الخمس من جانبي الوجود والعدم، أما من جانب الوجود، فيكون بتشريع ما يوجدها ويقيمها ويكملها ويقويها، وأما من جانب العدم، فيكون بتشريع ما يكفل بقاءها واستمرارها، ويدرأ عنها ما يفوتها أو يخل بها، ويحميها من أي اعتداء واقع أو متوقع عليها.
وإذا علمنا هذه الحقيقة الجليلة، وأن الشريعة كلها مبناها على تحقيق المصالح ودرء المفاسد، في كل أحكامها وتشريعاتها، وأوامرها ومنهياتها، فليس معنى ذلك أن المصلحة المعتبرة التي يبنى عليها الأمر والنهي، والتحليل والتحريم هي ما نراه بمفهومنا القاصرة، وعقولنا المحدودة المشوبة بشوائب الهوى والشهوة، والمتأثرة بمؤثرات الواقع المعاش والبيئة المحيطة، فكثير من الناس ـ وبخاصة في زماننا اليوم مع الانفتاح الإعلامي الكبير وتنوع وسائل الاتصال والتواصل ـ أخذ يتجرأ على جناب الشريعة، ويتصدى للتحليل والتحريم، محتجاً بهذه الحقيقة وهي أن الشريعة إنما جاءت لتحقيق مصالح الخلق، فيقرر الأحكام بناء على ما يراه بعقله القاصر، وتهواه نفسه الأمارة بالسوء، ويزعم أن هذا هو ما تقتضيه المصلحة، وأنه هو حكم الله، دون أن ينظر في الأدلة الشرعية، ويتعرف من خلالها وكلام العلماء المعتبرين حولها على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيه، وقد يكون في واقع الأمر محرماً منهياً عنه، وهو عين المفسدة، أو فيه مفاسد كثيرة تربي على ما فيه من مصالح أو منافع.
وأخطر من هذا أن فئاماً من المتعالمين في زماننا اليوم، ممن جمعوا بين قلة الفقه ورقة الدين، واتباع الهوى، والإعجاب بالنفس، أخذوا يخوضون في أحكام الشريعة، ويفتون في كبار المسائل بلا حجة ولا دليل، ولا بينة ولا برهان، وإنما دليلهم هو المصالح المرسلة، التي تقررها عقولهم القاصرة، وتدعو لها أهوائهم الضالة وإراداتهم الفاسدة، فأباحوا كثيراً من المحرمات، وأنكروا كثيراً من المشروعات، لأنها بزعمهم خلاف المصلحة التي هي مقصود الشارع، بل وصل الحال ببعضهم إلى أن يتبنى ـ عن حسن نية أو سوء نية ـأحد هذين المنهجين الخطيرين، وكلاهما كفيل بهدم الدين والتشكيك في أحكامه القطعية، وثوابته الشرعية، وهما:
المنهج الأول: الزعم بأن علماء الشريعة معنيون بأحكام العبادات والأحوال الشخصية ونحوها، ولا شأن لهم بقضايا السياسة والاقتصاد والقضايا الاجتماعية والمسائل الطبية والهندسية وعلوم الفضاء وعلوم الأرض وعلوم البحار، والعلوم المدنية والعسكرية، فلا ناقة لهم فيها ولا جمل، وليس لنا أن نستفتيهم عن الحلال والحرام فيها، لأنهم ليسوا من أهلها، والمختصون فيها أعلم بوجوه المصالح والمفاسد فيها من علماء الشريعة البعيدين عنها...
وفي هذا الكلام خلط عجيب، وتلبيس شديد، وجهل فاضح، لأن معرفة هؤلاء المختصين بالطب أو الهندسة أو الصناعة أو السياسة أو الاقتصاد أو الاجتماع أو نحوها لا يعني أنهم يعرفون أحكامها وضوابطها الشرعية، وما يحل فعله منها وما يحرم، وإن كانوا هم المرجع المعتمد في تكييف هذه المسائل وتصويرها وشرح حقائقها وبيان ملابساتها لعلماء الشريعة، لكن معرفة هؤلاء المتخصصين بهذه العلوم وممارستهم لها لا تعني معرفتهم بحكم الشارع فيها، فالأحكام الشرعية وقضايا الحلال والحرام في جميع مجالات الحياة وشتى مرافقها مرجعها إلى علماء الشريعة والمتخصصين فيها.
ولست أنسى في هذا المقام موقفاً حصل معي في محاضرة مشهودة دعيت لإلقائها في المؤتمر السنوي لرابطة الشباب العربي المسلم في أمريكا، والذي يحضره ما يزيد على عشرة آلاف مسلم سنوياً، وكان موضوع المحاضرة حسبما طلب مني "الجمود والتجديد في الفقه الإسلامي"، وحين أردت البدء في المحاضرة أبدوا رغبتهم بأن يشاركني في الموضوع أحد المتخصصين في الهندسة المعمارية، ولكنه ـ كما ذكروا ـ مهتم بهذه القضية، حيث ألف كتاباً كاملاً عن "بناء الأحكام على المصالح في الشريعة الإسلامية"، فرحبت به وتوقعت أنه سيثري هذا الموضوع المهم، ويحصل التكامل بين ما عنده وعندي، وحين جاء دوره في الكلام سمعت منه أمراً عجباً، وهو يؤكد ما يقوله العلماء منذ القدم: من خاض في غير فنه أتى بالعجائب، ويدل كذلك على جراءة بعض المتحذلقين والكتبة على الخوض في بعض المسائل الكبرى في الشريعة وهم من أجهل الناس فيها، فيظلمون أنفسهم ودينهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً!!
وكان مما قال: أنا مهندس معماري أعلم من جميع علماء الشريعة بالهندسة المعمارية وقواعدها ومدارسها وآلياتها ووسائل تنفيذها، وإذا أراد أحد من هؤلاء العلماء أن يبني مسجداً أو بيتاً فنحن أهل الاختصاص في هذا المجال، ونحن الذين نرسم التصميم المناسب لهذه المباني وأمثالها ـ وإلى هنا فكلامه لا اعتراض عليه ـ ولكنه أردف قائلاً: وما دمنا نحن المختصين بالهندسة المعمارية فنحن أعلم بالمصالح والمفاسد في هذا المجال، ولا حاجة بنا لسؤال العلماء عن ما يحل ويحرم من أعمالنا وتصميماتنا، لأننا أعلم منهم بها!!
ثم أردف قائلاً: وكذلك الحال بالنسبة للأطباء الذين هم أعلم بالطب ووسائله من علماء الشريعة البعيدين عن هذا المجال، وتجد الواحد منهم لا يحسن خياطة جرح أو إجراء عملية جراحية صغيرة، أو صرف دواء لما يعانيه هو أو غيره من الأدواء المعتادة، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا يستفتى هؤلاء العلماء في القضايا الطبية والعمليات الجراحية والأدوية العلاجية؟! بل كل طبيب يقدر المصلحة ويعمل بمقتضاها، لأن الشريعة الإسلامية مبناها على جلب المصالح ودرء المفاسد!!
وبعد أن فرغ شكرته على مشاركته ودعوت له بالمغفرة والتوفيق وقلت له: إن المقدمات التي ذكرتها في حديثك ورتبت عليها النتيجة النهائية صحيحة لا غبار عليها، ولكن النتيجة خاطئة قطعاً، ودليل صحة تلك المقدمات قول الله تعالى: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} وأهل الذكر هم المتخصصون في كل شأن من شؤون الحياة، فإن كانت القضية طبية رجعنا إلى الأطباء لتشخيصها وتوصيفها ومعرفة الوسيلة المناسبة لمعالجتها وحلها، وإن كانت هندسية فنرجع لأهل الهندسة، وإن كانت فلكية رجعنا لعلماء الفلك، وإن كانت حاسوبية رجعنا للمتخصصين في الحاسوب، وإن كانت اقتصادية رجعنا لأهل الاقتصاد، وإن كانت سياسية رجعنا لأهل السياسة... وهكذا.
أما كون النتيجة التي قررتها خاطئة فمن ثلاثة وجوه:
الأول: ليس كل ما يسمى مصلحة في اللغة أو العرف، أو يراه الناس أو طوائف منهم مصلحة يمكن أن يكون مصلحة مقصودة للشارع، تشرع لتحصيلها الأحكام، ويؤمر بها المكلفون. وكذلك الحال بالنسبة للمفسدة التي هي ضد المصلحة.
فالمراد بالمصالح والمفاسد: ما كانت كذلك في نظر الشرع، لا ما كان ملائماً أو منافراً للطبع، فما شهد له الشرع بالصلاح فهو المصلحة، وما شهد له بالفساد فهو المفسدة، والخروج عن هذا المعيار معناه اتباع الهوى، والهوى باطل لا يصلح لتمييز الصلاح من الفساد، قال الله تعالى: {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ}[ص: 26]. فليس ثمّة إلا الحق أو الهوى، والحق هو ما جاء به الشرع الحنيف، وما عداه فهو الهوى.
الثاني: لو كانت العقول البشرية المجردة قادرة على تمييز الحلال من الحرام، وإدراك المصالح والمفاسد الحقيقية لما كانت هناك حاجة لإرسال الرسل وإنزال الكتب السماوية!، والعقول البشرية تتفاوت تفاوتاً كبيراً في تقدير المصالح والمفاسد، فما يراه بعض الناس مصلحة يراه آخرون مفسدة، بل إن الإنسان ينقض اليوم ما أبرمه بالأمس، ويفعل الشيء يظنه حقاً ومصلحة ثم يتبين له بعد حين أنه باطل ومفسدة، ولهذا كان من أعظم نعم الله علينا أنه لم يكلنا إلى أنفسنا وعقولنا المحدودة القاصرة، وإنما شرع لنا الشرائع وسن لنا الأحكام ليصلح أحوالنا في الحياة وبعد الممات، وأكرمنا بالوحي المعصوم الذي يهدي للتي هي أقوم، {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ}، وأعلم الناس بهذا الوحي ومقاصده وقواعده هم علماء الشريعة، الذين يجب على المهندس والطبيب، والخاص والعام، أن يرجع إليهم في معرفة الحلال والحرام، خصوصاً في المسائل التي تختلف فيها الأنظار، وتتباين بشأنها العقول والأفهام، وكما لا يجوز لغير الأطباء أن يتصدوا للتطبيب ووصف الدواء، ولا يجوز لغير المهندسين المعماريين أن يتصدوا للتخطيط وتصميم البناء، فكذلك لا يجوز لغير علماء الشريعة أن يتصدوا للإفتاء في مسائل الحلال والحرام، ويدعوا إلى الإقدام أو الإحجام بلا خطام أو زمام!!
الثالث: إذا كان المهندس المعماري أعلم من علماء الشريعة بالتصميمات الهندسية وطرائقها وآلياتها، فهل يستطيع المهندس الجاهل بالأحكام الشرعية أن يجزم بحكم وضع التصميمات الهندسية التي تشتمل على الصور والتماثيل, وحكم ترصيع الجدران أو الأبواب بالذهب والفضة أو غيرهما من المعادن النفيسة، وحكم التصميمات التي تنكشف من خلالها العورات، وحكم وضع أجهزة التنصت والتجسس في الأسقف والجدران والأرضيات، وحكم وضع المراحيض باتجاه القبلة استقبالاً واستدباراً، وحكم رفع البناء أو فتح الطاقات التي يتأذى بها الجيران، أو قد تستخدم على التلصص عليهم وكشف عوراتهم، وأمثال هذه المسائل التي قد يتردد في حكمها العلماء الراسخون، فضلاً عن العامة والمتطفلين على الشريعة، وإن كانوا يحملون شهادات عليا في الهندسة أو غيرها من العلوم الدنيوية؟!!
إن هذه المسائل وأمثالها تحكمها نصوص شرعية كثيرة، وقواعد فقهية متنوعة لا يعلمها حق علمها إلا علماء الشريعة، وهم المرجع في تقدير الحلال والحرام فيها.
وإذا كان الطبيب أعلم بالطب والأدوية والجراحات الطبية المتنوعة من علماء الشريعة، فهل يستطيع الطبيب الجاهل بالأحكام الشرعية أن يعرف حكم الجراحة الطبية، وحكم العمليات التجميلية على اختلاف أنواعها، وحكم التداوي بالأدوية المشتملة على السموم أو الخمر أو الخنزير، وحكم إجهاض الأجنة، وحكم قطع النسل أو استئصال الرحم، وحكم أطفال الأنابيب بصورها المختلفة، وحكم نقل الدم والأعضاء وحكم بيعها وشرائها، وحكم إعادة الأعضاء المقطوعة في القصاص والحدود، وحكم بنوك الحليب وبنوك الحيوانات المنوية، وحكم ما يسمى بالقتل الرحيم، وحكم نزع أجهزة الإنعاش عن فاقد الوعي أو الميت دماغياً، وحكم الاستنساخ، وحكم تغيير الجنس والتلاعب بالجينات والهرمونات... وهكذا.
إن هذه المسائل وأمثالها لا يمكن معرفة ضوابطها الشرعية، ومعرفة المباح منها والحرام إلا عن طريق علماء الشريعة، الذين هم أعلم بنصوص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة ومقاصدها من هؤلاء الأطباء، مهما بلغوا في الحذق والذكاء، ودورهم يقتصر على مجرد تكييف هذه المسائل للعلماء وبيان نتائجها وآثارها الجانبية، وكل ميسر لما خلق له.
وكثير من هذه المسائل محل خلاف بين كبار العلماء في أصل مشروعيتها أو في شروطها وضوابطها، فكيف يصح لطبيب غير متخصص أن يفتي فيها ويقدم عليها، بحجة أنه يرى المصلحة في ذلك، وأن الشريعة مبناها على المصالح؟!!
المنهج الثاني:طرح بعض المسلمات الشرعية، والثوابت القطعية للاستفتاء عبر الصحف والمجلات، والمواقع والقنوات، جاهلين أو متجاهلين ما ورد في بيان حكمها من الأدلة القطعية في ثبوتها ودلالتها، وذلك كالاستفتاء حول حكم الربا وحكم الزنا والشذوذ الجنسي، وحكم الحجاب الشرعي، واشتراط الولي في النكاح، وحكم سفر المرأة دون محرم، وخلوتها بالرجل الأجنبي، واختلاطها بالرجال الأجانب في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية والأهلية، وحكم الولاء والبراء، والجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعقوبات الشرعية، وغيرها.
وينسى هؤلاء أو يجهلون أن المصالح التي تتراءى لنا تنقسم ـ كما يقول العلماء ـ من حيث اعتبارها وإلغاؤها إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: المصالح المعتبرة، وهي التي دل الدليل الشرعي على اعتبارها ورتب عليها الأحكام.
القسم الثاني: المصالح الملغاة، وهي التي دل الدليل الشرعي على إلغائها وعدم اعتبارها، فلا يجوز بناء الأحكام عليها.
القسم الثالث: المصالح المرسلة، وهي التي لم يدل الدليل على اعتبارها ولا إلغائها، ولهذا سميت مصالح مرسلة.
أما الأول والثاني فحكمهما ظاهر، فالمرجع فيهما إلى ما دل عليه الدليل الشرعي في الاعتبار أو الإلغاء، وليس لنا أن نخالف ما دلت عليه الأدلة الشرعية بحجة الأخذ بمبدأ المصلحة التي هي مقصود الشارع من تشريع الأحكام.
وأما القسم الثالث، وهو الذي سكت عنه الشارع، فلم يمنعه أو يشرعه، فإنه محل اجتهاد، ينظر فيه الراسخون في العلم ليعرفوا حكمه من خلال مقاصد الشريعة وقواعدها العامة، كالقياس والاستحسان والاستصلاح وغيرها، وليس للعامة وأهل الأهواء مدخل فيه، كيف وقد قال الله تعالى: {وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ} وقال: {وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ}، وقال: {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ}، وقال: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ}.
وقال الله تعالى متوعداً من يقول عليه بلا علم: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً}، وقال: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ}، وبين سبحانه أن القول عليه بلا علم من الكذب، وأن الكذب عليه عز وجل ليس ككذب على غيره فقال: {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.
ومن هنا يتبين أهمية معرفة المعيار الصحيح والضابط الشرعي لمعرفة المصالح والمفاسد التي تبنى عليها أحكام الشريعة.
وهذا ما سأبينه في الجزء الثاني من هذا المقال بإذن الله.
الكلمات الدلالية (Tags):
لا يوجد
-
 المعيار الشرعي لمعرفة المصلحه والمفسده---
المعيار الشرعي لمعرفة المصلحه والمفسده---

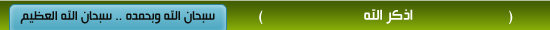
الدمعه- طيف- رضى رزقتم الجنه بلا حساب ----والجميع---- -
 رد: المعيار الشرعي لمعرفة المصلحه والمفسده---
رد: المعيار الشرعي لمعرفة المصلحه والمفسده---

(2ـ2)
المصلحة المعتبرة شرعاً هي التي تتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية من حفظ ضرورات الناس وحاجاتهم وتحسيناتهم، فليس كل ما يسمى مصلحة في اللغة أو العرف، أو يراه الناس أو طوائف منهم مصلحة، يمكن أن يكون مصلحة مقصودة للشارع، تشرع لتحصيلها الأحكام، ويؤمر بها المكلفون. وكذلك الحال بالنسبة للمفسدة التي هي ضد المصلحة.
فالمراد بالمصالح والمفاسد: ما كانت كذلك في نظر الشرع، لا ما كان ملائماً أو منافراً للطبع. وهذا هو الذي أكده الغزالي في تعريفه للمصلحة، حيث قال: "أما المصلحة، فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة، أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكنا نعني بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشرع".
إذاً فمعيار المصلحة والمفسدة هو الشرع، فما شهد له الشرع بالصلاح فهو المصلحة، وما شهد له بالفساد فهو المفسدة، والخروج عن هذا المعيار معناه اتباع الهوى، والهوى باطل لا يصلح لتمييز الصلاح من الفساد، قال الله - تعالى – {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ}[ص: 26].
فليس ثمّ إلا الحق أو الهوى، والحق هو ما جاء به الشرع الحنيف، وما عداه فهو الهوى، فالمصلحة الشرعية ليست هي الهوى أو تحقيق الأغراض الشخصية، والطموحات المادية، ذلك أن أهواء الناس متباينة، ورغباتهم مختلفة، وطموحاتهم متفاوتة، والإنسان بدافع من هواه وشهوته يسعى إلى تحصيل كل مستلذ ملائم، ودفع كل شاق منافر، وإن كان في ضمن ذلك ضرر قد يلحق به أو بغيره من الناس، أو به وبهم حالاً أو مآلاً.
يقول الشاطبي في "الموافقات1/349": "إن المصالح التي تقوم بها أحوال العبد، لا يعرفها حق معرفتها إلا خالقها وواضعها، وليس للعبد بها علم إلا من بعض الوجوه، والذي يخفى عليه منها أكثر من الذي يبدو له، فقد يكون ساعياً في مصلحة نفسه من وجه لا يوصله إليها، أو يوصله إليها عاجلاً لا آجلاً، أو يوصله إليها ناقصة لا كاملة، أو يكون فيها مفسدة تربي في الموازنة على المصلحة، فلا يقوم خيرها بشرها. وكم من مدبّر أمراً لا يتم له على كماله أصلاً، ولا يجني منه ثمرة أصلاً، وهو معلوم مشاهد بين العقلاء. فلهذا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين.
فإذا كان كذلك، فالرجوع إلى الوجه الذي وضعه الشارع، رجوع إلى وجه حصول المصلحة على الكمال، بخلاف الرجوع إلى ما خالفه"
فإن اللذة العارضة قد تعقب آلاماً ومفاسد كبيرة حالاً ومآلاً، وذلك كشرب المسكرات وتعاطي المخدرات، وارتكاب الفواحش والمنكرات.
وإن القعود والراحة قد يعقبان ذلة ومهانة، وخساراً كبيراً وتعباً طويلاً. وذلك كترك الجهاد في سبيل الله، طلباً للراحة، وإخلاداً إلى الأرض.
وإنّ كسب المال مصلحة لكاسبه، ولكن كسبه بالطرق المحرمة، كطريق الربا أو الرشوة أو أكل مال اليتيم أو غيرها من أنواع أكل أموال الناس بالباطل، فيه ظلم للغير وإضرار بهم، مع ما فيه من محق البركة وإتلاف النفس والمال.
وعلى العكس من ذلك، نجد أن بعض وسائل المصالح مؤلمة وشاقة، ولكن عواقبها حميدة، ونتائجها حسنة، وذلك كآلام العلاج والمداواة، وكألم الجهاد في سبيل الله ومقاتلة أعداء الله، قال الله - عز وجل - {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}[البقرة: 216]، وقال - تعالى – {إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللّهِ مَا لاَ يَرْجُونَ}[النساء: 104].
ومن ذلك العقوبات الشرعية، فإنها مؤلمة لمن أقيمت عليهم، ولكنها تعود بالخير العميم على المعاقب نفسه، وعلى المجتمع بأسره. قال العز بن عبد السلام في "قواعد الأحكام 1/12": "وربما كانت أسباب المصالح مفاسد فيؤمر بها أو تباح، لا لكونها مفاسد، بل لكونها مؤدية إلى المصالح، وذلك كقطع الأيدي المتآكلة حفظاً للأرواح، وكالمخاطرة بالأرواح في الجهاد، وكذلك العقوبات الشرعية، كلها ليست مطلوبة لكونها مفاسد، بل لحكمها المقصودة من شرعها، كقطع السارق وقطع قطاع الطريق، وقتل الجناة، ورجم الزناة وجلدهم وتغريبهم، وكذلك التعزيرات، كل هذه مفاسد أوجبها الشرع، لتحصيل ما رتب عليها من المصالح الحقيقية، وتسميتها بالمصالح من مجاز تسمية السبب باسم المسبب".
إذاً فالمصلحة الشرعية هي المحافظة على مقاصد الشارع ولو خالفت مقاصد الناس، لأن مقاصد الناس - والحالة هذه - ليست مصالح حقيقية، بل أهواء وشهوات وآراء فاسدة ألبستها العادات والأعراف ثوب المصالح.
ولو استعرضنا التاريخ الماضي والواقع المعاصر لوجدنا لذلك أمثلة كثيرة ومتنوعة، أذكر منها ما يأتي:
1ـ كان أهل الفترة يرون أن المصلحة في وأد البنات، وحرمان الإناث من الميراث، وقتل غير القاتل، وما كانوا يعتقدون أن في شرب الخمر ولعب الميسر، ونسبة الولد إلى غير أبيه، ونكاح زوجة الأب، ونكاح الاستبضاع، وغيرهما من أنكحة الجاهلية الفاسدة مفسدة، وهي كلها - في نظر الشارع - مفاسد، وحكم الإسلام فيها معروف.
أخرج البخاري (حديث رقم: 5127) عن عائشة - رضي الله عنها -: (أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليّته أو ابنته في صداقها ثم ينكحها. ونكاح آخر، كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبداً حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب. وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع.
ونكاح آخر، يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة، كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومرّ ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمّي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل.
ونكاح رابع، يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة، لا تمنع من جاءها. وهن البغايا كنّ ينصبن على أبوابهن رايات تكون علماً، فمن أرادهن دخل عليهن. فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها، جمعوا لها، ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاطته - أي: ألصقته - به ودعي ابنه، لا يمتنع من ذلك، فلما بعث محمد - صلى الله عليه وسلم - بالحق هدم نكاح الجاهلية كله، إلا نكاح الناس اليوم).
2- القانون الروماني، وهو في أوج عظمته، كان يجيز للدائن أن يسترقّ مدينه في الدين، إن هو عجز عن الوفاء.
وإذا كان هناك أكثر من دائن، ولم يوجد من يرغب في شراء المدين، فإن القانون أعطى للدائنين حق اقتسام جثة المدين. وما كان أحد في روما يرى أن في هذا الحكم مفسدة، حتى جاء الإسلام بذلك المبدأ العادل: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}[البقرة: 280].
3- القانون الإنجليزي ظل قرابة عشرة قرون، يرى أن المصلحة في حرمان النساء من الميراث، واستقلال الابن الأكبر بالتركة، وأن الميراث كحجر، إذا ألقي ينزل إلى أسفل، ولا يصعد إلى أعلى، ومن ثم فما كانوا يتصورون أن الأصول يأخذون نصيباً من الميراث. واستمر الحال على هذا حتى سنة 1925م تقريبا، حيث قرروا تشريك الإناث في الميراث، وتوريث الابن الأصغر، وتوريث أصول الميت، فرأوا أن المصلحة هي فيما جاءت به الشريعة الإسلامية.
4- القانون الأمريكي، ما يزال يرى أن المصلحة في إطلاق حرية الموصي، ولو أدى ذلك إلى أن يوصي الشخص بكل ثروته إلى خليلته، أو حتى كلبه أو حصانه، أو قطته، تاركاً ورثته دون أدنى نصيب من تركته. أما الشريعة الإسلامية فإنها قيدت حرية الموصي بما يكفل مصلحته ومصلحة الورثة على حد سواء، فأذنت له بالوصية فيما دون الثلث لغير وارث، وهو أمر مقرر في محله من كتب الفقه.
5- ومنها ما تفعله بعض قبائل "الأسكيمو" من تقديم الأزواج زوجاتهم إلى ضيوفهم، ليضاجعوهن. ويعدّون هذا من قبيل كرم الضيافة.
كما أن بعض القبائل الأفريقية درجت على إباحة مضاجعة إخوة الزوج لزوجته، طبقاً لطقوس خاصة.
6- وآخر مثل أذكره لإلباس الأهواء والشهوات ثوب المصالح، ذلك القانون الفاسد الذي أقره مجلس العموم البريطاني، ومجلس الكنائس الإنجليزية، باعتبار الشذوذ الجنسي عملاً مشروعاً بين البالغين، إذا كان برضاهم.
أي مصلحة في جعل هذه الفاحشة النكراء، وهذا الشذوذ المصادم للفطرة، عملاً مشروعاً، يجد قانوناً يقره، وسلطة تحميه؟! ولكنه التقدير الإنساني القاصر للمصلحة.
وقد ذكر ابن تيمية - رحمه الله – في (مجموع الفتاوى 11/344 – 345) أن الشريعة لا يمكن أن تهمل مصلحة قط، بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين، وأتم علينا النعمة، وتركنا النبي - صلى الله عليه وسلم - على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعده إلا هالك.
ثم قال - رحمه الله -: "لكن ما اعتقده العقل مصلحة، إن كان الشرع لم يرد به، فأحد الأمرين لازم له، إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر، أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة، لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة، وكثيراً ما يتوهم الناس، أن الشيء ينفع في الدين والدنيا، ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة، كما قال - تعالى - في الخمر والميسر: {قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا}[البقرة: 219].
وكثير مما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بدع أهل الكلام، وأهل التصوف، وأهل الرأي، وأهل الملك، حسبوه منفعة أو مصلحة نافعاً وحقاً وصواباً، ولم يكن كذلك.
بل الكثير من الخارجين عن الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس، يحسب كثير منهم أن ما هم عليه من الاعتقادات والمعاملات والعبادات مصلحة لهم في الدين والدنيا، ومنفعة لهم، {الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا}[الكهف: 104]، {وقد زين لهم سوء عملهم فرأوه حسناً...}.
ومن هنا ندرك أن الإنسان - مهما أوتي من العلم، وبلغ من العقل والفهم - فإنه عاجز بطبيعته عن الإحاطة بالمصالح الحقيقية، وكيفية الوصول إليها في الدنيا والآخرة، وهو إن أدرك بعضها، فإنه عاجز عن إدراك جميعها، وما أدرك منها فإنه لا يهتدي إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقها، قال الله تعالى: {وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً}[الإسراء: 85].
هذا مع أن العقل لا يسلم في الغالب من مؤثرات البيئة وشوائب الأهواء والشهوات، والعواطف والنزعات، ويدل لذلك أن الناس يتناقضون في أحكامهم، بل الشخص الواحد يناقض نفسه، فينقض اليوم ما أبرمه بالأمس، ومن أجل ذلك كان الإنسان في ضرورة حقيقية ماسة إلى الاهتداء بالشرع القويم، الذي يفتح بصيرته وينير له الطريق ويهديه إلى سواء السبيل، ويكفل له مصالحه في دنياه وآخرته.
وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله – في (مجموع فتاوى ابن تيمية 19/99 – 100): "والرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده، فكما أنه لا صلاح له في آخرته إلا باتباع الرسالة، فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة، فإن الإنسان مضطر إلى الشرع، فإنه بين حركتين: حركة يجلب بها ما ينفعه، وحركة يدفع بها ما يضره، والشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه وما يضره، والشرع نور الله في أرضه، وعدله بين عباده، وحصنه الذي من دخله كان آمناً.
وليس المراد بالشرع: التمييز بين الضار والنافع بالحس، فإن ذلك يحصل للحيوانات العجم، فإن الحمار والجمل يميزان بين الشعير والتراب، بل التمييز بين الأفعال التي تضر فاعلها في معاشه ومعاده، كنفع الإيمان والتوحيد، والعدل والبر والتصدق والإحسان، والأمانة والعفة، وإخلاص العمل لله، والتوكل عليه، والتسليم لحكمه، والانقياد لأمره.. وتصديقه وتصديق رسله في كل ما أخبروا به، وطاعتهم في كل ما أمروا به، مما هو نفع وصلاح للعبد في دنياه وآخرته، وفي ضد ذلك شقاوته ومضرته في دنياه وآخرته.
ولولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش والمعاد، فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف مننه عليهم، أن أرسل إليهم رسله، وأنزل عليهم كتبه، وبين لهم الصراط المستقيم. ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام والبهائم، بل أشر حالاً منها".
ويقول الإمام الشاطبي في (الموافقات 2/48): "ولذلك لما جاء الشرع بعد زمان فترة، تبين به ما كان عليه أهل الفترة من انحراف الأحوال عن الاستقامة وخروجهم عن مقتضى العدل في الأحكام" إلى أن قال: "فالعادة تحيل استقلال العقول في الدنيا بإدراك مصالحها ومفاسدها على التفصيل".
ويؤكد هذه الحقيقة الإمام ابن القيم رحمه الله في (مفتاح دار السعادة 2/117 – 118) فيقول: "فالحاجة إلى الرسل ضرورية بل هي فوق كل حاجة، فليس العالم إلى شيء أحوج منهم إلى المرسلين - صلوات الله عليهم أجمعين -، ولهذا يذكّر - سبحانه وتعالى - عباده نعمه عليهم برسوله، ويعد ذلك عليهم من أعظم المنن منه، لشدة حاجتهم إليه ولتوقف مصالحهم الجزئية والكلية عليه، وأنه لا سعادة لهم ولا فلاح ولا قيام إلا بالرسل... فلولا النبوات لم يكن في العالم علم نافع ألبتة ولا عمل صالح ولا صلاح في معيشة، ولا قوام لمملكة، ولكان الناس بمنزلة البهائم والسباع العادية، والكلاب الضارية التي يعدو بعضها على بعض... ولهذا كان كل موضع ظهرت فيه آثار النبوة، فأهله أحسن حالاً، وأصلح بالاً، من الموضع الذي يخفى فيه آثارها. وبالجملة فحاجة العالم إلى النبوة أعظم من حاجتهم إلى نور الشمس، وأعظم من حاجتهم إلى الماء والهواء الذي لا حياة لهم بدونه".
وإن اعتماد بعض الناس في فهم المصالح والمفاسد على خبراتهم العادية وموازينهم العقلية، هو الذي جعلهم يتصورون أن التعامل بالربا ضرورة لا بد منها لتنشيط الحركة التجارية، والنهوض بها.
وهو الذي صور لهم أن الجمع بين الرجال والنساء في دور التعليم وشتى مرافق الحياة مصلحة اجتماعية، حيث يهذب الخلق، ويحد من شرّة الميل الجنسي، ويمنع من التعدي والاغتصاب ـ زعموا ـ!!
وهو الذي صور لهم أن العقوبات الشرعية، كعقوبة القصاص، وقطع السراق، ورجم الزناة، وجلد السكارى، غير ملائمة لهذا العصر، لما تنطوي عليه من قسوة وبشاعة، أو تعطيل لبعض طاقات المجتمع.
وهو الذي صور لهم أن الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وللذب عن دينه وحشية وهمجية لا تلائم روح العصر، ولا تتفق ومواثيق الأمم المتحدة، والأعراف الدولية السائدة.
وهو الذي صور لهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيه تعد على حريات الناس، وتدخل في خصوصياتهم، فيجب تركه وإهماله.
إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي يطالعنا بها بين الحين والآخر أناس لم يستنيروا بنور الشرع، ولم يهتدوا بهدي الله {وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ}[الزمر: 23]، {وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ}[النور: 40].
يقول الإمام الشاطبي في (الموافقات 2/37ـ40): "المصالح المجتلبة شرعاً، والمفاسد المستدفعة، إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية، أو درء مفاسدها العادية"، ثم ذكر لذلك أربعة أدلة، وهي - باختصار – كالآتي:
الأول: أن الشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين عن دواعي أهوائهم، حتى يكونوا عباداً لله اختياراً كما هم عبيد له اضطراراً.
وهذا المعنى - إذا ثبت - لا يجتمع مع فرض أن يكون وضع الشريعة على وفق أهواء النفوس، وطلب منافعها العاجلة كيف كانت، وقد قال ربنا - سبحانه وتعالى - {وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ}[المؤمنون: 71].
الثاني: أن المنافع الحاصلة للمكلف مشوبة بالمضار عادة كما أن المضار محفوفة ببعض المنافع، ومع ذلك فالمعتبر إنما هو الأمر الأعظم، وهو جهة المصلحة التي هي عماد الدين والدنيا، لا من حيث أهواء النفوس، حتى إن العقلاء قد اتفقوا على هذا النوع في الجملة، وإن لم يدركوا من تفاصيلها قبل الشرع ما أتى به الشرع، فقد اتفقوا في الجملة على اعتبار إقامة الحياة الدنيا لها أو للآخرة، بحيث مُنعوا من اتباع جملة من أهوائهم بسبب ذلك.
هذا وإن كانوا بفقد الشرع على غير شيء، فالشرع لما جاء بين هذا كله، وحمل المكلفين عليه طوعاً أو كرهاً، ليقيموا أمر دنياهم لآخرتهم.
الثالث:أن المنافع والمضار عامتها أن تكون إضافية لا حقيقية، ومعنى كونها إضافية، أنها منافع أو مضار في حال دون حال، وبالنسبة إلى شخص دون شخص، أو وقت دون وقت، فكثير من المنافع تكون ضرراً على قوم لا منافع، أو تكون ضرراً في وقت أو حال، ولا تكون ضرراً في آخر.
وهذا كله بيّن في كون المصالح والمفاسد مشروعة أو ممنوعة، لإقامة هذه الحياة، لا لنيل الشهوات، وإقامة هذه الحياة ليس لها وإنما للآخرة. ولو كانت موضوعة لنيل الشهوات، لم يحصل ضرر من متابعة الأهواء، ولكن ذلك لا يكون، فدل على أن المصالح والمفاسد لا تتبع الأهواء.
الرابع: أن الأغراض في الأمر الواحد تختلف، بحيث إذا نفذ غرض بعض وهو منتفع به، تضرر آخر لمخالفة غرضه، فحصول الاختلاف في الأكثر يمنع من أن يكون وضع الشريعة على وفق الأغراض، وإنما يستتب أمرها بوضعها على وفق المصالح مطلقاً، وافقت الأغراض أو خالفتها.
ولقد أطلت الكلام في هذه المسألة، وأكثرت من النقول فيها، نظراً لأهميتها وخطورتها، ودعوة الحاجة إلى تقعيدها وتجليتها، خصوصاً في هذا الزمن الذي عمد فيه الجهلة والعلمانيون والمستغربون إلى الإسلام ينقضونه عروة عروة، وإلى شريعته الغراء فيهملونها حكماً حكماً، كل ذلك باسم المصلحة.
صيد الفوائد
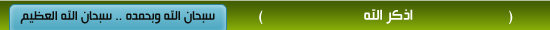
الدمعه- طيف- رضى رزقتم الجنه بلا حساب ----والجميع---- -
 رد: المعيار الشرعي لمعرفة المصلحه والمفسده---
رد: المعيار الشرعي لمعرفة المصلحه والمفسده---
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
اشكرك اختي على الكلمات النيرات





