كود: [عرض]الفن والأدب ملزمان بالارتقاء بذوق الإنسان ليتفاعل مع البيان الإلهي، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على روحه وعلى كيانه كله فيدرك دوره الحقيقي في الوجود، ويدرك أن لوجوده وظيفة يتحتم معرفتها وأداؤها بروح جمالية
لأدب نشاط إنساني يولد مع الإنسان، ولكي يكون جميلاً قويًّا مؤثرًا خالدًا، يتوجب عليه الاسترشاد بالبيان الذي خطت معالم خريطته مفصلة في الكون والوجود، وأنزلت مرتكزاته على محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم. وبعبارة أخرى، إن الأدب لا يستحق صفة الأدبية إلا في ظل "البيان"، وذلك باقتران دقة الوسيلة والأداة والكلمة(1) في إطارها العام بالبيان في مستواه الثاني، لأن الكلمة إذا لم تتطلع إلى أن تكون في مستوى البيان الحقيقي وتجتهد لأجل ذلك، فستكون مجرد زيف لا يلبث بريقها أن يبهت ويعتريه الصدأ.
فهؤلاء متأكدون أن أرواحهم إذا لم تتشرب روح البيان فإن حركيتهم ستظل مفتقرة إلى النضج والانسجام، ولن ترقى أفعالهم ولا أقوالهم في مقامات الاكتمال، وستظل بعيدة عن التناغم والانتظام في دائرة البيان الكلي حيث يأخذ كل عنصر مكانه في جو من التوازن والتناسق. وبعبارة أخرى، إذا افتقرت الأفعال والأقوال لروح البيان فلن تجد مكانها الطبيعي والمنطقي ضمن سلسلة البيان الكلي، بل إن وجودها بقرب العناصر الأخرى التي حصلت مشروعية الدخول في دائرة البيان، يصير عنصرًا مزعجًا وحالة مرضية، بل ورمًا خبيثًا يتوجب بتره.
إن مظاهر التفاعل مع البيان تتعدد، وسبل محاكاته تتنوع بحسب مستويات التفاعل مع هذا البيان باعتباره إطارًا عامًّا يحدد العلاقة، ويبني المنهج ويرسم الجادة وفنون القول على وجه الخصوص، التي توظف الكلمة بمفهومها اللغوي أهم المجالات التي تحتاج إلى استحضار مفهوم البيان، بل هي أهم المكونات المرتبطة بالإنسان ارتباطًا مباشرًا حاجةً إلى التفاعل مع البيان واستحضاره.
ينقسم الأدب إلى قسمين كبيرين يعكسان تلك العلاقة الأزلية التي يتصارع فيها الخير مع الشر، أو تتنازع فيها قوى الخير مع قوى الشيطان؛ ففي الوقت الذي تسعى فيها قوى الخير إلى ربط صلة الفن والأدب بالبيان وحقائقه، تعمل الأخرى على إفساد العلاقة الأولى.
لقد ضل الصنف الأخير الطريق، وتوقفت بوصلته منذ خلق الله آدم عليه السلام، وأمره الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر فطرد من رحمة الله، وأنظره الله إلى يوم يبعثون... ولذلك يجلس الشيطان للإنسان في طريق العودة إلى المكان الذي أُخرج منه عندما خالف آدم وزوجه حواء أمْرَ الله وأكلا من الشجرة المحرمة. ومنذ ذلك الحين يعيش الإنسان فصول معركة لا تنتهي من أجل العودة إلى هذا الفردوس، والفن والأدب في الأصل نوع من التغني بهذا الفردوس. لكن الشيطان لا يمل من إفساد اتساق كل نغمة وكل ما يقرب من البيان الكلي الذي ينير طريق العودة. وبضاعة من جندوا لهذه المهمة هي البضاعة السائدة في هذا الزمن الصعب، وهي تدعي امتلاكها شفرة الوصول إلى السعادة، ولعمري إنه مجرد وهم ليس غير.
سبل الارتقاء في مقامات الوصول عديدة، ومنها الارتباط بالروح والوجدان والجوارح بأمنية العودة إلى فردوس مفقود، من خلال لحن جميل متوازن، أو نص اختمر طويلا في رحم وَلّادة حتى اكتملت معالمه واجتمعت محاسنه، ليولد بعد مخاض ولادة طبيعية، وليس ولادة قيصرية.
المخاض العسير وسهر الليالي الطوال ومعاناة تحقيق نشوة الاكتمال هذه، هي مكونات الأدب الذي يدور في دائرة البيان المطلق. وبعبارة أخرى، إنه البحث عن الكمال، بل هو البحث المستمر من أجل الوصول إلى ملامسة حقيقته. فلكل أديب نموذج فردوسي مفقود يبحث عنه بما يراه مناسبًا لذلك، ولذلك كان الأدب الرفيع على مر العصور، معاناة أليمة وعذابًا مريرًا ومخاضًا عسيرًا.
على هذا المنهج صار فحول الكلمة من أمتنا عبر مختلف العصور والأزمنة، بعد أن اختط كل فحل لنفسه في دائرة هذا المنهج سبيلاً خاصًّا يميزه، وأسلوبًا يطبع مخاض نصه، ومعاناة تختم إبداعه... فالحلاج وابن عربي مثلاً في بحثهما عن الحقيقة أدركا بآدميتهما استحالة الإمساك بكل خيوط البيان المطلق، لكنهما أصرا -كما أصر غيرهما- على البقاء في دائرة المعاناة... فكل مقام يصلونه، يمثل بداية السير إلى مقام آخر لتبدأ الرحلة من جديد. فأما الحلاج فقد حلق ولم ينزل، وأما ابن عربي فظل قلبه متعلقًا بالسماء هائمًا في المظاهر البيانية التي تجود بها، وظلت روحه مشرئبة هائمة في الملكوت، لكن على علو منخفض، ولم يتقدم مخافة الاحتراق.
ولذلك فالأدب في أصل وجوده رحلة بحث طويلة، وللأستاذ فتح الله كولن رأي في هذا الباب مضمونه أن الأدب مهما بلغ من القوة الفنية والعمق الجمالي والقدرة على التأثير، إذا لم يكن مؤسسًا على الخطاب الإلهي ولم يستنر بنور مملكته، يعتبر جماله جمالاً نسبيًّا، لأن هذا الجمال يفتقر إلى المعنى الحقيقي للجمال، بل هو مجرد إحساس موهوم.
إن التجربة الأدبية بهذا المفهوم محضن تجارب كثيرة، وليس بمقدور أحد الادعاء بأنه نسيج وحده باستثناء البيان القرآني. فكل تجربة من هذا المنظور، هي في الحقيقة ملتقى تلتقي فيه تجارب الماضي بخصوصيات الحاضر؛ فتجربة اليوم تمتاز عن تجربة الماضي بما تحمله من خصوصيات الحاضر، لكنها تحمل خصوصيات الماضي كذلك ولا يمكنها التجرد عن ذلك ولا التنكر له، بمعنى أن التجربة الأدبية لا تكتمل معالمها المركزية إلا في ظل الخطاب الإلهي وعندما تكون بوتقة يلتقي فيها ثراء الماضي وتجاربه بخصوصيات الحاضر ومتطلبات العصر، لكن برؤية تتطلع إلى المستقبل أفضل من الحاضر ومن الماضي نفسه.
الكلمات الدلالية (Tags):
لا يوجد
-
 الأدب في ظل البيان د.محمد جكيب
الأدب في ظل البيان د.محمد جكيب

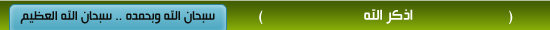
الدمعه- طيف- رضى رزقتم الجنه بلا حساب ----والجميع---- -
 Re: الأدب في ظل البيان د.محمد جكيب
Re: الأدب في ظل البيان د.محمد جكيب
الأدب في ظل الأدبية
إن مادة الأدب هي اللغة بكلماتها وآفاقها الدلالية وصورها الفنية البلاغية، لكنها الغذاء الذي يغذيها يقطف من عالم المشاعر والوجدان والأحاسيس ومن كل جميل، ولكونها كذلك، فهي تظل مرتبطة بالإنسان باعتباره كائنًا مركبًا متقلبًا بين الغموض والوضوح. وهذا هو ما يجعل الأدب أبعد ما يكون عن صرامة العلم.(2) لكن مع ذلك يمكن تفريع الأدب إلى فرعين:
الفرع الأول هو فرع "الأدبية"، أي ما يصنع أدبية الأدب، وما يجعل من الأدب جنسًا لغويًّا يختلف كثيرًا عن اللغة التي توظف في الخطاب العادي، ولا مناص للأدبية من الموهبة إلى جانب العناصر الأخرى. فالموهبة هي الطاقة التي تشحن اللغة وتفعلها لتوجد منها شيئًا أدبيًّا، وهي منحة إلهية لا تمنح للكل وإلا تحول الأدب إلى شيء مبتذل لا يختلف عن الكلام العادي، وتقوم المعرفة بتقنيات الكتابة وسبلها ونظرياتها ومناهجها وأجناسها وأنواعها الأدبية، بمهمة مد الموهبة بالأشكال التي تستوعب اللغة المشحونة بـ"الأدبية".
إن الأدب الرفيع لا تصنعه التقنية بقدر ما يصنعه عنصر الموهبة والملَكة التي تحسن توظيف التقنيات فتختار المناسب من الأجناس، ولهذا تجد الشاعر والقاص والروائي وغير ذلك... كل واحد يعبر بالجنس الأدبي القريب منه، والجنس الذي تبدو تقنياته في متناوله، لكن القاسم المشترك هو التواصل المعنوي مع القلوب والعقول والأرواح بحسب منطلقات الأديب، وهنا تكمن وظيفة الأدبية.
وأما الفرع الثاني فيهتم بما يحيط بأحوال الإبداع الأدبي دراسة وتحليلاً وتنظيرًا ونقدًا وتأريخًا، وهذه المجالات هي المجالات الأكثر ارتباطًا بمفهوم "علم الأدب"، وسيلعب هذا المجال في المستقبل، دورًا أساسيًّا في تقريب المكونات السامية للأدب في ظل البيان ومعطياته عندما تميل الإنسانية كلها إلى العلم وحقائقه. وفي هذه المرحلة ستصبح الحاجة إلى البيان أكثر إلحاحًا من قبل، لأن من شأن حقائق العلم أن تبين حقائق الوجود وتجلي عناصره.
بعبارة أخرى، إن الواقع العلمي سينتهي إلى الانسجام الكامل مع الخطاب القرآني ومع البيان الكلي، والأدب نفسه سينتهي ليكون تعبيرًا عن هذه الحقيقة، أي أن يشرح ويقرب البيان إلى كل العقول والأفهام، وسيخاطبهم بأسلوبه ويوظف كل التقنيات التي تفتح القلوب والأرواح بأسلوب خاص.
يؤكد الأستاذ فتح الله كولن أن سلطة الكلمة ضرورية لانتقال الأفكار من ذهن إلى آخر ومن قلب إلى آخر، والذين يحسنون استعمال هذه الواسطة من أرباب الفكر، يستطيعون جمع الأنصار للأفكار التي يريدون زرعها في القلوب والأرواح، فيصلون بأفكارهم إلى الخلود. وأما الذين لا يحسنون ذلك، ولا يستطيعونه فسيقضون أعمارهم في معاناة فكرية، ويرحلون عن الدنيا دون أن يتركوا فيها أثرًا. ولما كان العنصر الأساسي في الأدب هو المعنى، فقد وجب أن تكون الكلمات المذكورة قليلة لكن غنية بالمعاني. وهي موجودة في الكلام العميق عند المفكرين من ذوي القلوب الملهمة المحيطة بالوجود، والذين تتسع قلوبهم للوجود كله، من ذوي الخيال الواسع الذين نجحوا في أن يروا الدنيا والآخرة وجهين لحقيقة واحدة، والذين يملكون إيمانًا عميقًا وفكرًا تركيبيًّا قويًّا.(3)
ومن أجل فهم دقيق لنظرية الفن المستظلة بظل البيان الكلي، يتوجب ربط الفن بصفة عامة والأدب على وجه الخصوص، بمقصد ووظيفة تروم إيجاد إنسان بمميزات تؤهله لإدراك أبعاد البيان في أفق إعمار الأرض والوجود، ومحاصرة أعداء الإنسان؛ "الجهل" و"الفقر" و"التفرقة".
فالفن والأدب ملزمان بالارتقاء بذوق الإنسان ليتفاعل مع البيان الإلهي، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على روحه وعلى كيانه كله فيدرك دوره الحقيقي في الوجود، ويدرك أن لوجوده وظيفة يتحتم معرفتها وأداؤها بروح جمالية. وبعبارة أخرى، إن يدرك الإنسان محله من البيان، فيتفاعل معه التفاعل اللازم له، بل إن العلم الذي ستنتهي إليه الإنسانية هو العلم بموقع الذات/الذوات في تفاعلها مع الوجود.
وأما محاصرة الأدب للفقر فتلمس في توسيع أفق الإنسان وفتح روحه وقلبه على العالم الفسيح وعلى الوجود في اتساعه وامتداده، ومن شأن ذلك فتح الآفاق والدخول في دائرة الإبداع بالتذوق أو بالإبداع والانطلاق، وترك المسكنة والدروشة.(4) وبعبارة أخرى، إن ترك المسكنة يعني أن يكون الإنسان عالي الهمة كالنسر، يرتاد أعالي الجبال ولا يرضى بسفوحها ويقبل الخنوع. والفن بصفة عامة والأدب على الخصوص وبمختلف أجناسه يصنع هذا النوع الإنساني.
وأما دور الأدب في محاربة التفرقة، فتظهر من خلال استمداد الأدب مشروعية وجوده من البيان حتى يصير المنطلق الذي تنطلق منه كل الرؤى والأفكار والتصورات، وتحتكم إليه في كل ما يعرض لها أثناء المسير، وإذا استطاع شد الألباب -كما هو حال البيان المطلق- فإن توحيد نظر الجموع وتمازج الأفئدة حتى تصير كفؤاد واحد، هو المصير الأكيد. ومن شأن ذلك جعل المواقف تلتقي عند الكليات وتتوحد حول الأساسيات، وليس في ذلك أي إلغاء للخصوصيات الفردية ولا الجماعية، لأن هذه الخصوصيات مصدر من مصادر إثراء التجربة.
إن مراد البيان الكلي هو أن يكون الناس على إيقاع واحد ووفق نبرة واحدة، ولا شك في أن سبل الوصول إلى ذلك متعددة ومتنوعة، لكن الفن بصفة عامة والأدب على الخصوص وبمختلف أجناسه ومختلف أنواعه الموجودة، وحتى تلك التي ستظهر في المستقبل، تستطيع توحيد الأرواح على إيقاع واحد.
إن من تعلقت أرواحهم وقلوبهم وأفئدتهم بالبيان، تنتظرهم مهمة كبيرة وعظيمة... فالذين اختاروا الأدب لأداء مهمتهم، يتوجب على أقلامهم أن تصنع من الكلام سبيلاً ينشر الخير والبشائر في كل العوالم المعنوية والمادية دون تمييز بينهما، لأن المهمة واحدة والغاية واحدة، ولأن المرمى هو أسمى مرمى يمكن للإنسان أداؤه. فالأيادي الجافة التي لم تدرك حقيقة البيان الكلي، والتي حجب غباؤها وضلال روحها عنها إدراك هذه الحقيقة، يستحيل عليها أن تكون مرشدًا إليه ودالاًّ عليه تعالى.(5) وعلى هذا القلم أن يدرك بأن العالم في حاجة إليه، وأن الزمان قد دار دورته، وأن الأرض سيرثها الصالحون. وإذا لم يكن القلم في داخل الدائرة، فإن فراغًا قاتلاً سيحتل المكان وتعشش فيه قوى الشر، لذلك على الفن بصفة عامة وعلى الأدب بصفة خاصة، أن يسكت شبه الأقلام التي أطالت الكلام دون فائدة، والنور لم تنشر والخير لم تبلغ والعالم لم تضئ، وإسكاتها لا يكون إلا بأن تنتشر الأقلام المتوضئة في كل مكان، وفي كل قلب، وفي كل حدب وصوب، وفي الأرض والجو كله... فإذا تكلم القلم الصالح، خنست الأقلام الجوفاء وانكتم ضجيجها وغلب النور الظلام، وزدانت الأرض والسماء بنور ربها.(6)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
الهوامش
(1) نعني بالكلمة هنا، كل نظام ترميزي يوظف للتعبير والتواصل كالألوان والإيقاعات الموسيقية وغيرها.
(2) بعض النظريات الأدبية تقول بـ"علم الأدب"، متأثرة في ذلك بما تحقق في مجال العلم الطبيعي من إنجازات، وبغض النظر عما تطرحه هذه الرؤية من إشكالات معرفية، فإن القضية تحتاج إلى تأمل خاص.
(3) انظر تفصيل هذه الرؤية في كتاب الأستاذ البيان Speech.
(4) ترك الدروشة بالمفهوم السلبي لا بالمفهوم الإيجابي، التي تعني الخضوع لله تعالى.
(5) مستلهم من نص الأستاذ فتح الله كولن في مؤلفه "ألوان وظلال في مرايا الوجدان": "تضرُّعُ قلم" يقول: تكلم يا قلم، واصرخ يا مداد، "يا من بالقلم أقمت! أعوذ بك أن تلمسني يد جافة، ويستخدمني عقل غبي! وروح ضال... وهبني -يا رب- إلى من إليك يكتب، وعليك يدل".
(6) مستلهم من نص الأستاذ فتح الله كولن في مؤلفه "ألوان وظلال في مرايا الوجدان": "لسان نور" يقول: ما أكثر ما قالوا فما أناروا... وما أكثر ما تكلموا فما أضاؤوا... ثم صمتوا، وما عاد عندهم ما يقولون... تكلم أنت، فالدور دورك... فقد أظل زمانك، وأقبلت أيامك... الوجدان إليك يهفوا، والروح إليك يرنو، فتكلم وأضئ، والأنوار فأشعل... بالنور لسانك مغموس، إذا تكلم، أضاءت الدنيا، وأشرق العالم، وتولى الظلام، وصلح الإنسان.
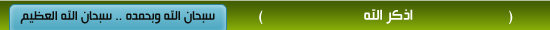
الدمعه- طيف- رضى رزقتم الجنه بلا حساب ----والجميع---- -
 رد: الأدب في ظل البيان د.محمد جكيب
رد: الأدب في ظل البيان د.محمد جكيب
بارك الله فيك
ربي آسالك ثلاثه 1 : جْنِھٌ آلفردوس 2 : ۈحُسْنَ آلخآتمِہٌ 3 : ۈرضآ آلوالدين آمَين يارب .. وإياكم -
 Re: الأدب في ظل البيان د.محمد جكيب
Re: الأدب في ظل البيان د.محمد جكيب
كلمات ذات فوائد جمه نفع الله بك وبما كتبت وبوركت جهودك







