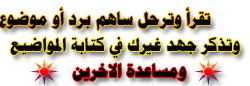أبرأ إليك مما صنع خالد
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وبعد: قد جاء الإسلام بحفظ الحقوق وإقامة العدل، وتحريم الظلم والعدوان. قال الله - جل ثناؤه-: "ياعبادي! إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا"، وإن من أعظم الظلم والعدوان أن يعتدى على المسلم في ماله أو دمه أو عرضه، وهذا الأصل العظيم من الدين قرره نبينا - صلى الله عليه وسلم - وبيّنه في آخر وصية لأمته يوم حجة الوداع. أخرج البخاري في صحيحه عن أبي بكرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه قال: أيُ يوم هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب". وفي رواية "وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالاً يضرب بعضكم رقاب بعض".
وكفى بهذا الحديث النبوي بياناً في حرمة دم المسلم وتعظيم الاعتداء عليه بغير حق.
فكيف وقد جاء في ذلك آيات وأحاديث عظيمة تبين خطورة الاعتداء على الدماء والاستهانة بها.
يقول – سبحانه-: "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً" (النساء:93)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً" [أخرجه البخاري].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لزوال الدنيا أهول عند الله من قتل رجل مسلم" [أخرجه الترمذي والنسائي].
بل لقد أنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - على أصحابه الذين قتلوا من عنده شبهة إسلام لعظم الدماء والأرواح عند الله أن تزهق بغير حق.
يقول أسامة بن زيد - رضي الله عنه -: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، فطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا بلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لي: "يا أسامة، أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله" قلت: يا رسول الله إنما كان متعوذاً – أي قالها: ليتقي سيوفنا – فقال - صلى الله عليه وسلم-: "أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله" قال أسامة: فما زال يكررها عليّ حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم" [متفق عليه].
فانظر إلى هذا الموقف، على الرغم من أنه كان في جهاد حق، وقتل رجلاً مشركاً في ظاهره ومحارباً لهم، أنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - قتله لشبهة إسلامه، فكيف بمن يقتل المسلمين الغافلين بشبهة باطلة، أو لدعاوى فاسدة، مع أنهم مسلمون يصلون ويصومون ويزكون.
إن أمر الدماء عند الله عظيم، فقتل الكافر بغير حق جرم عظيم، وقد روى البخاري حديث عمر - رضي الله عنه -: "من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة"، فكيف بالمسلم. لقد عد موسى - عليه السلام - قتله لرجل من آل فرعون كافراًخطأً معصية يعتذر بسببها عن الشفاعة العظمى يوم القيامة، وقال كما حكى الله في القرآن: "فَعَلْتُهَا إِذاً وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ" (الشعراء:20)، وثنى إثر مقتل الرجل بقوله: "رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ" (القصص: من الآية16)، وكل ذلك يدلك على أن سفك الدماء المعصومة بغير حق ورطة كبرى وجريمة عظمى، فكيف بها إذا كانت هذه الدماء دماء مسلمة لا ذنب لها ولا جرم عليها.
قال ابن عمر - رضي الله عنهما - كما في الصحيح: "إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله"، وما ذاك إلا لأنها معظمة عند الله، ومن عظمها أنها أول ما يقضى فيه يوم القيامة من الحقوق كما جاء في الصحيحين عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء".
إن حرمة المسلم عظيمة عند الله، بل كما قال ابن عمر إن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة، فوجب أن تصان، وأن تحفظ.
الإسلام يرفق حتى بالحيوان:
لقد بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا الدين رحمة للعالمين، عالم الإنس والجن، بل حتى عالم الحيوان.
أخرج أبو داود في سننه بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فانطلق لحاجته، فرأينا حُمَّرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمَّرة فجعلت تفرش، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: "إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار".
فانظر كيف منع - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أن يروعوا طيراً في صغارها، فكيف بمن روّع المسلمين في بلدهم الآمن؟
وقد منع النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه من تحريق النمل، فكيف بمن حرّق أجساد المسلمين الغافلين، الذين لا يعلمون فيم قتلوا؟ ولأي شيء أحرقوا بالمتفجرات؟
ولئن دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت ظلماً وعدواناً، فكيف بمن قتل مسلماً ظلماً وعدواناً.
وأخرج أبو داود في سننه بسند صحيح عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني النبي - صلى الله عليه وسلم - خلفه ذات يوم، قال: فدخل حائطاً لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - حنّ وذرفت عيناه، فأتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فمسح ذفراه فسكت. فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار، فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه".
إن هذا الدين الخاتم الذي يمنع أذى الحيوان والعدوان عليه لحري به أن يعظم أذى الإنسان والعدوان عليه بغير حق، بل وأعظم من ذلك أن يحرم العدوان على المسلم المصلي الذي يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله.
فتن في بلاد الحرمين:
إن ما حدث في هذه البلاد من تفجيرات في الأيام القريبة أو البعيدة ما هو إلا إفساد في الأرض كبير، وهتك لحرمات الله، واستهتار بالدماء المحرمة.
وإن التفريق بين الناس بناء على وظائفهم، فهذا مواطن، وهذا رجل أمن مستباح الدم، افتيات على الشرع، فالكل مسلم، والكل قد حرم الله دمه وعظم الاعتداء عليه، بل إن الاعتداء على من يقوم على حفظ الأمن وحفظ الحقوق أعظم خطراً من الاعتداء على سائر الناس.
وإن هذه الفتنة العمياء ابتدأت صغيرة، فقد كانت محض آراء وأهواء، ثم أمست كما نراها الآن؛ سفك لدماء المسلمين وترويع للآمنين، وهكذا الفتن تبدأ صغيرة فينفخ فيها الشيطان حتى تكون عمياء فلا يدري القاتل فيم قَتَل ولا المقتول فيم قُتِل.
والتاريخ شاهد على مثل هذه الفتن، فالخوارج ابتدأت بدعتهم يوم أن أنكر كبيرهم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قسم، وانتهت بقتل الخليفتين الراشدين عثمان وعلي - رضي الله عنهما - وقتل عدد كبير من أجلة الصحابة والتابعين.
واجب الأمة:
إن من واجب الأمة بجميع فئاتها؛ علماء، وولاة، وعامة، أن يقفوا في وجه هذه الفتنة وفي وجه هذا الإفساد، وأن يتق الله كل من يبرر لهؤلاء أو يتعاطف معهم لأجل بعض ما يطلقونه من شعارات مضللة، أضرت بالإسلام والمسلمين، والجهاد والمجاهدين.
والواجب على العلماء وطلبة العلم أن يقفوا في وجه هذه الفئة التي شوهت وجه الجهاد الحق، والمجاهدين الصادقين، وأضرت بثغور الجهاد، ونصرة قضايا المسلمين.
ومن الواجب كذلك على العلماء وطلبة العلم والدعاة والمربين أن يفتحوا قلوبهم وأبوابهم، لكل من تأثر بمثل هذه الأفكار ليقنعوهم بالحجة والبرهان، وليس حقاً ولا عدلاً أن يسفهوا ويلغظ لهم بالقول؛ لتصبح أفكارهم حبيسة صدورهم،ومجالس مشبوهة، ثم بعد ذلك تتحول إلى خلايا وعمليات، يفسد أصحابها في الأرض، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً.
ومن الواجب كذلك في مثل هذه الفتن، قطع السبيل على المرجفين والمنافقين، الذين لايحلو لهم الجو إلاّ إن تعكر، فعندها يتنفسون ويخرجون ويتكلمون، فيلقوا بالتهم جزافاً على كل مناشط المجتمع التربوية والإسلامية، وعلى مظاهر التدين ومناهج التعليم؛ في محاولة للإيحاء بأن الدين والتدين، وكل من يدعو إلى الخير والصلاح هم سبب هذه الظاهرة، وهم من ينبت هذه النابتة، وغرضهم من ذلك شق صف المجتمع وإثارة البلبلة والتطاحن بين الناس؛ لكي يصفوَ لهم ما يريدون من إشاعة أفكارهم المنحطة، وأخلاقياتهم المنحرفة بزعم أنها هي المنهج الوسط الذي يأمن به المجتمع.
ولقد غفل هؤلاء أو تغافلوا عن أن الخوارج وهم أعظم جرماً وأشد خطراً، حيث قتلوا صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأوغلوا في دماء المسلمين، ومع ذلك كان خروجهم في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي زمن أصحابه، ولم يكن هذا لأجل مظاهر التدين في تلك الحقبة أوذلك المجتمع، ولم يكن –كما يزعمون- بسبب سوء الخطاب الديني أو حدته، ولم يكن أيضاً بسبب آيات القرآن التي تحث على الجهاد والاستشهاد في سبيل الله أو مقاتلة الكافرين أو معاداتهم.
ولم يدع خروجهم أيضاً إلى تبديل الخطاب الديني أو إلى تغيير المناهج التي تعلمت عليها الأمة، أو إلى نبذ الجهاد والتحذير منه، أو إلى التملص من الدين ومظاهر التدين؛ لأن الأمة في ذلك الزمن تعلم علم اليقين أن خروج مثل هذه الطوائف المنحرفة إنما هو بسبب الجهل والبعد عن دين الله وعدم تعلمه وأخذه عن العلماء الربانيين، فالجهل والهوى هو طريق الانحراف، وهو سبيل الفساد والإفساد.
وأما الدين والتدين والسنة والعلم الشرعي الصحيح فهو سبيل النجاة والأمن للمجتمع.
ثم على الأمة أن تعلم أن ما أصابها إنما هو ابتلاء وبلاء من الله بسبب الذنوب، فالأمن والطمأنينة لا تصنع بالأيدي مهما أوتينا من قوة حتى نرجع إلى الله وننخلع من ذنوبنا وظلمنا لأنفسنا وللناس "الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ" (الأنعام:82).
فالإعراض عن الله وعن دينه، والإقبال على المنكرات؛ بترك الصلوات، وأكل الربا، وشيوع الفاحشة، والاستهزاء بدين الله، والظلم، والعقوق، وقطع الأرحام، كل ذلك وغيره من أعظم أسباب ما نحن فيه من الفتن التي كنا بالأمس نسمع عنها ونشاهدها عبر وسائل الإعلام في البلاد من حولنا وإذا بها اليوم تقع بين أيدينا وبأيدي أبنائنا.
"وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ" (هود:117).
"وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ" (القصص: من الآية59).
"وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ" (النحل:112).
"وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ" (الأعراف: من الآية96).
وختاماً.. أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فجعلوا يقولون: صبأنا، فجعل خالد يقتل فيهم ويأسر، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فرفع النبي - صلى الله عليه وسلم – يده، فقال: "اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد".
هذا وهو خالد سيف من سيوف الله، ويجاهد المشركين، ووقع منه ذلك خطأ لا عمداً، ومع ذلك تبرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - من فعله.
ونحن نقول: اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل هؤلاء المفسدون، اللهم إنا نبرأ إليك من أفعالهم وأفكارهم وأهوائهم.
نسأل الله أن يحفظ المسلمين من الفتن، وأن يردهم إليه رداً جميلاً، وأن يحفظ بلادهم من كيد الأعداء والمنافقين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ/فهد العيبان | 20/3/1425
موقع المسلم
الكلمات الدلالية (Tags):
لا يوجد
-
 أبرأ إليك مما صنع خالد
أبرأ إليك مما صنع خالد